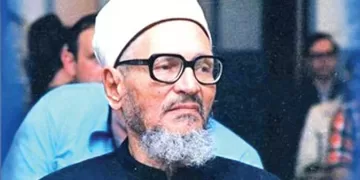بقلم أ.د. نادية قطب إبراهيم
أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الإعلام
-بنات- جامعة الأزهر
تشهد كليات وأقسام الإعلام في السنوات الأخيرة تحديًا حقيقيًا في جذب اهتمام طلابها نحو دراسة وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون والراديو والصحافة الورقية. فجيل اليوم من الطلبة لم يعد متابعًا لهذه الوسائل، ولا يثق في محتواها، ولا يجد فيها ما يثير اهتمامه أو يتناسب مع عاداته الاتصالية اليومية. أصبح الطالب يعتمد في معرفته وثقافته العامة وحتى في تشكيل آرائه وسلوكياته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تقدم محتوى سريعًا، متجددًا، ومتعدد الأشكال، لكنها في المقابل تفتقر إلى الدقة والمصداقية والضوابط المهنية.
هذا التحول خلق فجوة معرفية واتصالية واضحة بين أعضاء هيئة التدريس الذين نشأوا وتكوّن وعيهم المهني في ظل هيمنة الإعلام التقليدي، وبين الطلاب الذين يرون العالم من خلال شاشات الهواتف والمنصات الرقمية. لم يعد الطالب يرى فائدة عملية من دراسة الصحافة أو الراديو أو التلفزيون، بل يعتبرها تخصصات “قديمة” لا تواكب العصر الرقمي. وهنا تكمن المشكلة الأكاديمية والمجتمعية في آنٍ واحد: إذا أهملنا دراسة الإعلام التقليدي، فإننا نفقد الجذور المهنية، وإذا تجاهلنا الإعلام الرقمي، فإننا نعزل أنفسنا عن الواقع الاتصالي الجديد.
ولعل الحل لا يكمن في المفاضلة بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، بل في دمج الرؤيتين داخل البرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية. يجب أن يدرك الطالب أن التلفزيون والراديو والصحافة الورقية ليست وسائل منتهية الصلاحية، بل هي مؤسسات إعلامية راسخة تطورت وتكيّفت مع التحول الرقمي. فالتلفزيون اليوم يُبث عبر الإنترنت، والصحافة الورقية أصبحت رقمية تفاعلية، والراديو تحول إلى “بودكاست” متاح في أي وقت.
تتطلب تجديد دراسة الإعلام التقليدي في كليات وأقسام الإعلام رؤية عملية تواكب التحولات الرقمية، وتحقق التكامل بين الإعلام الكلاسيكي والإعلام الإلكتروني ، من خلال تطوير المناهج وأساليب التدريس والتدريب الميداني. ويمكن تحقيق ذلك عبر مجموعة من الخطوات العملية، أهمها الربط بين القديم والجديد من خلال إدماج مواد دراسية تربط بين التلفزيون والبودكاست المرئي، أو بين الصحافة الورقية والإعلام الرقمي، بما يساعد الطالب على فهم تطور الوسيلة واستمرارية دورها بدلًا من تصور انقطاعها. كما ينبغي تحديث أساليب التدريس باعتماد مشروعات تطبيقية قائمة على الإنتاج الإعلامي المتكامل، بحيث يُطلب من الطالب تصميم مادة إعلامية تُبث عبر أكثر من منصة (تلفزيونية، وإذاعية، ورقمية)، مما ينمّي مهاراته التقنية والتحريرية في آنٍ واحد. كذلك يُعد الاستعانة بنماذج مهنية معاصرة من الإعلاميين الذين خاضوا تجربة التحول الرقمي خطوة مهمة، إذ يتيح للطلاب التعرف على كيفية الجمع بين الخبرة الكلاسيكية والابتكار الرقمي. إلى جانب ذلك، يجب غرس التفكير النقدي في عقول الطلاب من خلال تدريبهم على التحقق من المعلومات وفهم آليات التضليل والشائعات المنتشرة عبر المنصات الاجتماعية، ليُدركوا أهمية المهنية والضبط التحريري الذي تميزت به الوسائل التقليدية. وأخيرًا، فإن تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإعلامية يفتح مجالات تدريب حقيقية في القنوات والصحف الرسمية لتقريب الطلاب من بيئة العمل الواقعية، وجعلهم يكتشفون بأنفسهم أن الإعلام التقليدي ما زال أحد أهم مصادر المعلومات الموثوقة.
إن مستقبل دراسة الإعلام لا يجب أن يكون في صراع بين” قديم” و”جديد”، بل في صناعة تكامل معرفي ومهني يجمع بين صرامة التحرير التقليدي وسرعة الانتشار الرقمي. فإذا استطعنا أن نقنع طلابنا بأن الإعلام التقليدي ليس نقيض الإعلام الرقمي، بل هو أساسه ومنهجه المهني، فسوف نحافظ على هوية كليات الإعلام ورسالتها التنويرية في مواجهة فوضى المحتوى وغياب المعايير.
وفي النهاية، لا بد أن نؤمن بأن مهمة التعليم الإعلامي اليوم ليست تلقين أدوات الإنتاج فقط، بل بناء وعي نقدي قادر على التمييز بين الحقيقة والوهم، بين الإعلام المسؤول والإعلام المضلل، بين الحرية والفوضى .فالإعلام الحقيقي ليس في الوسيلة التي تُبث من خلالها المعلومة، بل في المنهج الذي تُصاغ به الحقيقة.