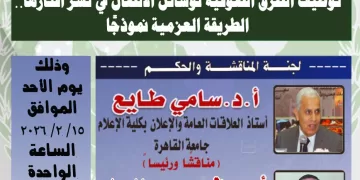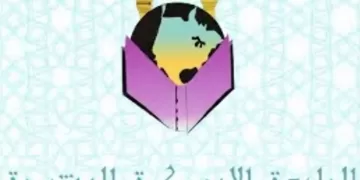د. الشافعي: التصوف اسم للجهود الفكرية والعملية
د. الجليند: الدروشة.. تشويهٌ شعبيٌّ للحقيقة
طـــــارق عبـــدالله
شهدت الساحة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية جدلًا واسعًا، بعد انتشار مشاهد الرقص والاحتفالات الصاخبة في مولد السيد أحمد البدوي، وهو أحد أبرز رموز التصوف الشعبي في العالم الإسلامي.
أثارت هذه المشاهد تساؤلات كثيرة حول حقيقة التصوف؟ والفرق بين التصوف كمذهب روحي فلسفي وبين ما يُعرف في الثقافة العامة بـ”الدروشة” أو الممارسات الشعبية التي ارتبطت به عبر القرون؟
ويخلط الكثير في مصر بسبب الأفعال التي تُمارَس في الموالد بين الصوفية والدروشة. ويجهل الكثيرون أن الصوفية بدأت كمذهب روحي فلسفي في علم الكلام، رغم أن التصوف منذ بدايته كان له جانبان الأول عملي ظاهر، والثاني روحي باطن.. فالأول يشمل مجاهدة النفس وفِطامها عن شهوتها وقطع علائقها بدنيا اللهو والغرور وإلزامها بآداب الدين، والثاني يتوجّه بصفة خاصة إلى الناحية الأخرى الروحية.
البيان الذي أصدرته المشيخة العامة للطُّرق الصوفية عقب ردود الأفعال لما ظهر عليه الأمر في مولد السيد البدوي، يؤكّد رفضهم لوجود هذه التجاوزاتٍ المحدودة، التي لا يمكن لها أن تنفي مشروعية الأصل وفقا للبيان، بل يستوجب التصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة. موضحة أن الاحتفال الرسمي للمشيخة بمولد السيد البدوي هذا العام تضمَّن استذكار سيرة السيد أحمد البدوي رضى الله عنه، ومواقفه الوطنية والإيمانية، واختُتم بالابتهالات والمدائح النبوية الخاشعة في أجواءٍ من الوقار والسكينة بعيدًا عن اللهو أو المبالغة .
وما يؤكد التزام الصوفية بمبادئها الحقيقية وبُعدها عن الدروشة، هو ما شدّدت عليه المشيخة– في البيان- بالتزامها بحماية التراث الروحي الأصيل، حيث أكدت بأن هو الإصلاح بالعلم، والرّدّ بالحجّة والتربية بالمحبّة، وأنّ من واجب الجميع صيانة مقامات أولياء الله من التشويه أو العبث، ورفض محاولات استغلال الرموز الدينية في تحقيق مكاسب إعلامية زائفة أو نشر الفتنة بين أبناء الوطن.
بين الفلسفة والدروشة
بداية يجب التفريق بين الصوفية باعتبارها مذهب روحي فلسفي، وبين الدروشة التي يمارسها البعض في موالد الأولياء.
ففي السابق كان التصوف فكرًا ساميًا يسعى إلى تهذيب النفس وسموّ الروح والارتقاء بالإنسان نحو معرفة الله عن طريق المحبة والتجرّد والصفاء. ومع مرور القرون، ومع دخول الجهل والبدع إلى بعض المجتمعات الإسلامية، تحوّل التصوف في بعض مظاهره الشعبية إلى ممارسات شكلية بعيدة عن أصله الروحي، حيث ظهرت ما يُعرف بـ”الطرق الصوفية” التي مزجت بين الذكر والإنشاد والرقص والطقوس الجماعية، وهو ما أدّى إلى ظهور مصطلح “الدروشة”.
التصوف الحقيقي
الرقص في الموالد، وضرب الطبول، والاختلاط المبالغ فيه ليست من جوهر التصوف، بل من الموروثات الشعبية التي أضيفت إليه بمرور الزمن. أما التصوف الحقيقي- كما يوضحه د. محمد السيد الجليند، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة في دراسته “فصول في التصوف”- فهو مذهب فلسفي يعبّر عن رؤية كونية تقوم على فكرة الوحدة بين الخالق والمخلوق بمعنى القرب الوجودي لا الحلول، وهي فكرة ناقشها العلماء بعمق واختلفوا حولها، وكان من رموزه في هذا الجانب الحلاج وابن عربي صاحبا نظريتي “الحلول والاتحاد” و”وحدة الوجود”، والسهروردي مؤسس “حكمة الإشراق”، وعبدالكريم الجيلي صاحب “الإنسان الكامل”.
ومن هنا يطالب د. الجليند، بالتمييز بين التصوف السنّي الأصيل الذي يجمع بين الشريعة والحقيقة، وبين المظاهر السطحية التي لا تمتّ إليه بصِلة. لافتا إلى أن التصوف هو جزءٌ من التراث الإسلامي العميق، وهو أيضا مدرسة للروح والإخلاص إذا ظل في إطاره الشرعي والفكري. أما الدروشة– من وجهة نظره- فهي انحرافٌ عن جوهره، ومشهد الرقص في المولد ليس إلا تعبيرًا عن الحاجة لإعادة تصحيح المفهوم، وإعادة الاعتبار للتصوف كمجالٍ للتزكية لا للفرجة. مشددا على أن الدروشة هي تشويهٌ شعبيٌّ للتصوف نتج عن الجهل بحقيقته وعن الخلط بين التعبير الروحي والمظاهر الاحتفالية.
ويرى د. الجليند أن موالد الأولياء في مصر وبلاد الشام والمغرب العربي تحمل بُعدين متداخلين، أولهما: البعد الديني، ويتمثل في إحياء ذكرى أولياء الله الصالحين الذين لهم مكانة في الوجدان الشعبي، وثانيهما: البعد التراثي الشعبي، وتتجلى أموره في مظاهر الاحتفال والأسواق والرقص والمدائح. ولكن المشكلة تظهر حين يطغى الجانب الشعبي على الجانب الروحي، فتتحول الموالد إلى مهرجانات ترفيهية تُفقد المناسبة معناها الديني.
كيفية النشأة
ويُعرّف د. حسن الشافعي- عضو هيئة كبار العلماء- التصوف- في دراسته “فصول في التصوف”- بأنه “اسم للجهود الفكرية والعملية التي بذلها وتبذلها طائفة من المتدينين والمسلمين أفرادا او جماعات، بقصد التعرف على الله، ومحاولة تحقيق الغايات الروحية والأخلاقية العليا للحياة الدينية الإسلامية”. لافتا إلى أن معنى الكلمة (صوفي) في اللغة العربية هي نسبة إلى الصفاء باعتبار أن الصوفي هو الذي صفا قلبه وتطهر وجدانه، وهناك من يرى أن “الصوفية” نسبة إلى “صوفة” وهي قبيلة عربية أو طائفة من أهل الجاهلية عرفت بالنسك وملازمة البيت الحرام فنسب إليها هؤلاء النساك والزهاد في ملتنا فقيل: صوفية. وهناك من العرب من يرى أن الصوفي نسبة إلى الصوف، ومنه اشتق التصوف باعتبار أن لباس الصوف هو مظهر الزهد والتقشّف والتقلّل من متاع الدنيا.
وقد ظهر التصوف– كما يوضح د. الشافعي- قبل سنة مائتين من الهجرة، ويمكن القول أنها ظهرت قبل منتصف القرن الثالث الهجري، حيث كان أبوهاشم الصوفي (ت262هـ) أحد المتّصلين بأحمد بن حنبل أول من عُرف بهذا الوصف، وإن كان البعض يعود به إلى أوائل القرن الثاني حيث يروي عن الحسن البصري (ت110هـ) أنه قال “رأيت صوفيا في الطواف، فأعطيته شيئا فلم يأخذه وقال: معي أربعة دوانيق، فيكفيني ما معي”. ويغلب على الظن أن الكلمة قد تردّدت على الألسنة وصفا لبعض الأفراد منذ منتصف القرن الثاني الهجري، ومنهم أبوهاشم وعبده الصوفي وجابر بن حيان الصوفي وغيرهم، ولكن الكلمة صارت على فئة أو مجموعة من المسلمين يتميزون بصفات معينة، كانوا يعرفون في الوقت نفسه بإسم “الزهَّاد” أو “النُسَّاك” أو “الجوعية” أو “القرَّاء”. أما المكان الذى ظهر فيه الاسم أولا فيحدده ابن تيمية بالبصرة. أما في القرن الرابع والخامس الهجري، فاتخذ التصوف طابعًا فكريًا أكثر عمقًا.
ويعتبر الإمام أبي حامد الغزالي– كما يؤكد د. الشافعى- هو الرجل الذي أسهم بأكبر قدر في جعل التصوف مقبولا لدى أصحاب السلطة في الإسلام، والقضاء على كل التشكّكات والظنون المسبقة حول التصوف عند علماء المسلمين المتشدّدين في أحكام الشريعة .
ويشدّد د. الشافعي، على أن التصوف اليوم لا يزال– من حيث الانتشار الجماهيري بين العامة– أقوى مؤسسة فيما نعتقد في العالم الإسلامي المعاصر، ومن تيسَّر له زيارة مناطق مختلفة من العالم الاسلامي لا يمكن أن ينكر هذا الحكم أيًّا كان موقفه من التصوف، وهناك مناطق معينة في أواسط أفريقيا وغربها، وشبه القارّة الهندية تهيمن الروح الصوفية على الحياة الإسلامية فيها، بينما تنازعها في مناطق أخرى توجهات ثقافية وسياسية مختلفة نوعا ما، مع استمرار التراث الصوفي وتوجّهاته الفردية والجماعية مؤثّرة في سلوكيات المجتمعات الإسلامية .
فتوى سابقة
الجدير بالذكر أن دار الإفتاء أصدرت فتوى رقم 606 عام 2005 ردّاً على سؤال حول حكم الموالد التي تقام للصالحين وتُرفع فيها الزينات والأنوار؟ وجاءت الفتوى لتؤكّد أن “إحياء ذكرى الأولياء والصالحين وحبهم والفرح بهم أمرٌ مُرَغَّبٌ فيه شرعاً؛ لما في ذلك من الباعث على التأسّي بهم والسير على طريقهم”. وأضافت الفتوى: “أما ما قد يحدث في هذه المواسم من أمور محرّمة، كالاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء، فيجب إنكارها وتنبيه أصحابها إلى مخالفة ذلك للمقصد الأساس الذي أقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة”.