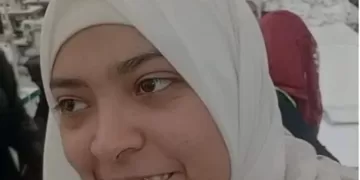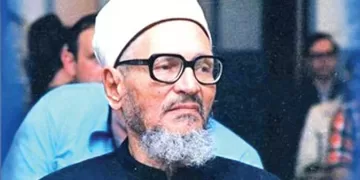بقلم أ.د/ نادية قطب إبراهيم
أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الإعلام جامعة الأزهر
في الأيام الماضية، شهدت مصر احتفالات مهيبة بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أكبر وأحدث المتاحف في العالم، جامعًا بين عبق التاريخ وروح الحاضر. وبينما امتلأت الشاشات بمشاهد الفخر الوطني، ارتفعت بعض الأصوات لتُثير تساؤلات حول مشروعية الاحتفال، معتبرةً أن إظهار الفرح بالتماثيل والآثار قد يدخل في باب “الحرام” أو “الشرك”. لكن هل حقًّا تُعدّ الآثار أو التماثيل التي خلفها المصريون القدماء من مظاهر الشرك؟ وهل الإسلام أمر بهدمها أو إخفائها؟ أم أن في تاريخنا ما يُظهر نظرةً أعمق، تُقدّر قيمة التاريخ من دون أن تمسّ جوهر التوحيد؟
من يقرأ القرآن الكريم بإنصافٍ وعمقٍ، يجد أن الله تعالى لم ينهَ عن معرفة التاريخ أو تأمل آثار الأمم السابقة، بل دعا إلى ذلك دعوةً صريحة في أكثر من موضع. قال تعالى: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ” (آل عمران: 137). وفي آية أخرى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ” (الروم: 9).
فالدعوة هنا ليست إلى الهدم، بل إلى التأمل في المصائر والعِبَر. الإسلام لم يمنع معرفة التاريخ ولا دراسة الحضارات، بل جعل التفكر في سنن الله في الكون عبادةً عقلية وروحية. وحين فتح عمرو بن العاص مصر سنة 20 هـ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يُؤمر بهدم الأهرامات أو التماثيل أو المعابد. بل تركت كما هي، لأن الصحابة فهموا أن هذه الآثار ليست أوثانًا تُعبد، وإنما شواهد على تاريخ الأمم.
يقول المؤرخ المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار إن “الصحابة لم يتعرضوا لشيءٍ من مباني الفراعنة، لأنها ليست معابد تُقام فيها عبادة لغير الله، بل آثارٌ باقية للعبرة”. وهنا يكمن الفارق الجوهري بين الأثر والوثن: الأثر: تركة إنسانية وتاريخية لا تُعبد ولا يُتقرّب إليها. الوثن: شيء يُتّخذ معبودًا أو يُعظّم تعبديًّا من دون الله. وقد فرّق القرآن الكريم بينهما حين ذكر قصة تابوت بني إسرائيل، فقال تعالى: “إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ” (البقرة: 248).
فهذا التابوت كان أثرًا تاريخيًا ودينيًا يحتوي على بقايا آثار من آل موسى وهارون، ومع ذلك كان موضع تكريم لا عبادة، لأنه يرمز للذكرى والإيمان وليس للشرك.
أما ما ورد في السنة النبوية من تحريم صناعة التماثيل بقصد التعظيم أو المحاكاة للخلق الإلهي، فهو خاص بنية العبادة أو التشبّه بالخالق، لا بتوثيق التراث أو حفظ التاريخ. قال النبي ﷺ: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله” (رواه البخاري ومسلم) وقد بيّن العلماء – مثل الإمام النووي وابن حجر العسقلاني – أن هذا النهي يختص بمن يصنع التمثال للتعبد أو التقديس، أما استخدامه في التعليم والتاريخ والعلم فليس داخلًا في النهي.
من هذا المنطلق، فإن احتفال المصريين بفتح المتحف المصري الكبير لا يمكن أن يُعد مظهرًا من مظاهر الشرك، ما دام لا يتضمن عبادةً أو تقديسًا لتمثال أو قبر، بل هو احتفاء بالحضارة والمعرفة، وإبراز لمكانة مصر التي ذكرها الله في مواضع عدة. قال تعالى: ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ” (يوسف: 99)، وذكرها النبي ﷺ في الحديث الصحيح حين قال: إِنَّكم ستَفتَحونَ أرضًا يُذكَرُ فيها القيراطُ، فاستَوْصوا بأهلِها خيرًا؛ فإنَّ لهم ذِمَّةً ورَحِمًا” (رواه مسلم).
فكيف لا نحتفي بمتحفٍ يجسد تاريخ أرضٍ باركها الله ووصّى نبيّه بأهلها؟ إن الاحتفال بالمتحف المصري الكبير ليس عبادةً لتماثيلٍ ولا تمجيدًا لأوثان، بل تحيةٌ لجهد الإنسان وتاريخ الأمة.
الإسلام لا يُعارض المدنية ولا الجمال ولا الفن، بل يوجّهها لتكون في خدمة القيم العليا. والتفرقة بين “التاريخ المادي” و“العبادة الروحية” ضرورة لفهم الدين في سياقه الصحيح. فلنفرّق بين من يُقدّس الحجر، ومن يستدلّ بالحجر على قدرة الله وتقلب الأمم. ولنعلّم أبناءنا أن التاريخ مرآة للعبرة، لا ميدان للعبادة.
فمن يتأمل آثار مصر بعين الوعي، يرى فيها آيةً من آيات الله في الخلق والقدرة والتاريخ، لا صنمًا ولا شركًا.